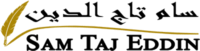بقلم حسام تاج الدين
أطفالنا وتربيتهم البيئية

“لمّا كانت الحروب تتولد في عقول البشر، ففي عقولهم يجب “أن تبنى حصون السلام“. عبر هذه الكلمات التي وردت في الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة)، تتوضح أهمية عملية الوعي البيئي من خلال التربية البيئية لعقل ومدارك الإنسان منذ نعومة أظفاره، لأنه هو المدمر والمنقذ لبيئته. ولعل أهم ما يجب التركيز عليه هو بناء وإرساء معالم التربية البيئية المبكرة في عقول أطفالنا لما لها من تأثير مباشر على سلوكيات الفرد لاحقاً. والخطوة الأهم التي يجب اتخاذها هي تطوير المناهج الدراسية النظرية مع إدخال الجوانب العملية لدفع الطفل نحو إشباع حاجاته وتنمية ميوله وإسهامه في حلّ مشكلات مجتمعه. ولابد من أن يترافق ذلك مع تهيئة الظروف والإمكانات المدرسية المناسبة لتحقيق الأهداف التي وضعت هذه المناهج من أجلها.
تعاود اليونسكو الطرح مجدداً في أجزاء من برنامجها عبر السؤال الآتي: (ما هي التربية التي ينبغي أن ننشئ عليها أولادنا في القرن الحادي والعشرين لإعدادهم لدخول عالم تزداد أطرافه ترابطاً كل يوم وتتسارع فيه التحولات؟
من خلال تَلمّس الإجابة عن هذا السؤال الهام المطروح على بساط النقاش، لعلنا لن نجد خياراً سوى تربية أطفالنا على مبادئ تربوية أخلاقية بيئية، لأنهم خط الدفاع المستقبلي الأخير لتوقف التدهور الأخلاقي البيئي المطرد والمتسارع. فربما لمّا يعد بإمكاننا إصلاح ما هو راهن، فليكن رهاننا بأطفالنا على ما هو قادم. ولكن يبقى السؤال الكبير المطروح “كيف؟”


لعل هذه الـ “كيف؟” لمّا تتأتى لنا من تفعيل العملية التعليمية البيئية في عقل الطفل بطريقة التفاعل المباشر مع المادة والابتعاد عن سبك المعلومات في العقل، لتنافي ذلك مع القواعد التربوية العلمية الحديثة. فالتربية الحديثة تقول بنقل مركز الاهتمام من المادة للمتعلم، حيث تأخذ بُعداً نفسياً يراعي اهتمامات المتلقي وحاجاته واستعداداته ومقتضيات بيئته وحياته المحيطة.
ينصبُّ في هذا المِضمار ما جاء في التقرير الختامي لمؤتمر “تبليسي” البيئي حيث أنه لا ينبغي أن تكون التربية البيئية مجرد مادة واحدة تضاف للبرامج القائمة، بل يجب إدخالها ودمجها ضمن المناهج التعليمية الأساسية على اختلاف المدارس والمناهج والأعمار، وإدخال مادتها الدراسية إلى أجزاء البرامج النظامية وغير النظامية كافة، لتكوين عملية واحدة عضوية متصلة. والفكرة الرئيسية في التحصيل تكون عن طريق الشمولية في المناهج مما ينعكس على الطالب ويجعله أكثر استعداداً للمشاركة في اتخاذ القرارات
وهذا لا يمكن عبر منهاج جامد سردي فقط، بل يجب أن يكون مرتبط ببرامج تطبيقية وأنشطة بيئية لا صفيّة جماعية تُعلّم الطفل روح التفاعل الحقيقي مع الموجودات الحسية والمكانية لبيئته. وتُربطْ أحياناً ببعض الجوائز التشجيعية لإبراز المتميزين وتحفيز الآخرين للعمل أكثر، ولكن على ألا تصبح هذه الجوائز هي الهدف أو العلامات في جدول نهاية العام الدراسي. لأننا نبتغي هدفاً وغاية تربوية مستدامة، وليس مادة أخرى تضاف لمناهجنا لتطوى مع طيّ العام الدراسي كغيرها.
من تراصف هذه النقاط مجتمعة يتراءى لنا أن محتوى التربية البيئية التي تُكتَسبْ من عدة مقررات علمية وتقنية من كيمياء وأحياء وعلوم اجتماعية وما إليها، تُنشئ الإنسان المزود بثقافة متكاملة، لتكوين ما يمكننا تسميته التمازج الإنساني الطبيعي الذي يؤلف بين الإنسان وبيئته ومجتمعه كلاً واحداً لا يتجزأ، حيث التغيرات التي تحدث للفرد في حاضره لها جذور في ماضيه وتؤثر على فيما سيحدث له في مستقبله. ولعلَّ أشد ما يعترض تقدم المسيرة البيئية هو انتشار قيم الاستهلاك من دون النظر لبناء الفكر الإنساني، والالتفات إلى المظهر دون الجوهر، وعدم الإحساس بالمسؤولية والحفاظ على ممتلكات البيئة العامة، وهنا يأتي دور الدولة والمجتمع عبر التشريعات والقوانين والمناهج الدراسية المكملة والتربية المنزلية المتوازنة والسليمة التي تتكامل عبر الإعلام لما له من دور وتأثير مباشر وفعّال على الأجيال كافة بمختلف المستويات والطبقات الاجتماعية.


وننصرف عمّا تَطرّق له البشر لنأتي على ما جاء على لسان سيد البشر سيدنا محمد (ص) لأنه هو مربينا الأول، حيث أن واقع القول يقول بأنه من رواد التربية البيئية؛ رغم حداثة هذا المصطلح، لكن هذا يتبين لنا من خلال الكثير من الأحاديث الشريفة يبتدئها المصطفى بحثنا بقوله: (ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)
هذه الفلسفة التي تنطلق من مبدأ إيماني مترابط مع مفهوم بيئي حضاري راقي يقوم على أنَّ استنزاف إي مورد طبيعي سيؤدي بنتيجة حتمية إلى خلل بطرف ما آخر، وهي متوالية حسابية منطقية ستستمر وتتنامى إن لم تُوقف عند حدّ معين. ولعل الأصح القول إننا من يجب أن نوقفها لأننا من أوجدها، لكن أهم ما يجب أن نحثُّ عليه أبنائنا هو هذه الوازع الديني البيئي الحق الذي أهملناه لجهلنا به، والذي ينص في أصله على التوازن ووجوب الذنب والمحاسبة مع الله تعالى في حال مخالفته، لأننا بالنهاية لا يمكننا أن نقول بمبدأ الحرية المطلقة للإنسان لأن نهاية حريتك تقف عند بداية حريتي، وبالتالي هما كُلٌّ واحدْ لأنْ أصاب أحدهما الضررَّ تداعى له الآخر كذلك. وفي نهاية الأمر نحن استُخلفنا من الله تعالى لإعمار هذه الأرض ونُحيها ونحافظ عليها، فإذا ما قمنا بتخريبها أثمنا جميعاً.
فلنبدأ نحن الآباء والأمهات والمعلمون بأنفسنا فمن لا يعمل بعلمه لن يستطيع أن يعلمه لغيره، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولنربي أطفالنا على أنه (إذا قامت على أحدكم القيامة وبيده فسيلة فليغرسها) كما علمنا نبينا، على هذا كان ديننا وعليه يجب أن نكون، وبالشكر تدوم النعم، والشكر لا يتمّ باللسان بل بالعمل الدؤوب والسعي، وخير ختام ما ذكره ربُّ الأنام قائلاً تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ* أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ* لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلا تَشْكُرُونَ) فلنرعى الله في أمانته التي أنزلها لنا ليرعنا ويحفظها علينا ويجزينا بها ويزدنا.